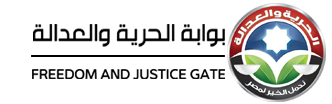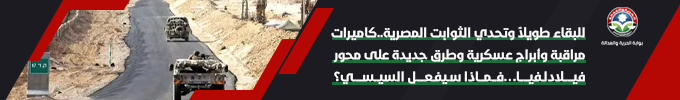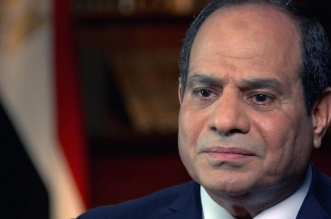يقسم المؤرخون فترات الحكم في مصر منذ فجر التاريخ إلى الدولة القديمة (الالف الرابع قبل الميلاد) والذي يسمى بعصر بناة الأهرامات ويبدأ من توحيد القطرين الشمالي والجنوبي على يد الملك مينا “نعرمر” سنة (3200 ق م)، ثم عصر بناة الأهرام. ثم مرحلة الضعف الأول حتى قيام الدولة الوسطى، وهو عصر الرخاء الاقتصادي وهو العصر الذي شهد قصة نبي الله يوسف عليه السلام وإنقاذ مصر من مجاعة كانت محققة وهو العهد الذي بلغت فيه مصر أوج قوتها ومجدها وكانت قبلة للجائعين والباحثين عن الرقي والحضارة والتمدين كما كانت قبلة للتوحيد وعبادة الإله الواحد. كان يطلق على حكام مصر خلال الدولتين القديمة والوسطى لقب “ملوك”. ثم جاء عصر الضعف الثاني في أواخر الدولة الوسطى حتى قيام الدولة الفرعونية الحديثة التي أسسها أحمس بعد طرد الهكسوس من مصر. وفي عصر الدولة الحديثة ولاسيما في عهد أسرة الرعامسة (رمسيس) بدأ يطلق على حكام مصر لقب “فرعون” ومعناه بالمصرية القديمة (صاحب البيت الكبير)، وفي عهد هذه الدولة جرت وقائع قصة نبي الله موسى عليه السلام وخروجه بقومه (بني إسرائيل) من مصر هربا من بطش فرعون وظلمه وظلم جيشه وجنوده. وصولا إلى مرحلة الضعف الثالث وانهيار الدولة المصرية القديمة ودخولها في مرحلة طويلة من الإذلال حيث بقيت لنحو ألفي سنة بعد فرعون محتلة من الأحباش تارة والفرس تارة أخرى واليونانيين تارة ثالثة والرومان الذين احتلوا مصر لنحو سبعة قرون كاملة.
جيشان دمرهما الله بيده
لم تعرف مصر جيشا نظاميا منذ جيشها الفرعوني الغارق في اليم (نحو 1200 ق م على الأرجح) في عهد الطاغية فرعون (رمسيس الثاني على الأرجح حسب أقوال كثير من المؤرخين)، حين كان يطارد المؤمنين الموحدين الذين كان يقودهم نبي الله موسى عليه السلام، إلا في عهد محمد علي باشا (1805 ـ1848م). كان لمصر في عهد الفراعنة جيش نظامي حقا ولكنه كان يفتقد إلى الإيمان الحق والإنسانية النبيلة والقيم الأخلاقية السامية، وقد سجل القرآن الكريم كثيرا من جرائم هذا الجيش في حق المؤمنين المستضعفين حتى استحق هذه النهاية المؤلمة والمخزية ليكون عبرة لكل جيوش الأرض من بعده؛ وتكفي الإشارة إلى أن القرآن الكريم لم يذكر جيشين تم تدميرهما بمعجزة إلهية سوى الجيش المصري حين شق الله اليم ونجى موسى والمؤمنين معهه وأهلك فرعوه وجيشه. والجيش الثاني الذي دمره الله هو جيش الأحباش (إثيوبيا حاليا) حين قرروا تدمير الكعبة بجيش ضخم تتقدمه الفيله فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
ولم تعرف مصر بعد جيشها الغارق جيشا مثله؛ لأنها مرت بمراحل طويلة من الضعف والهشاشة، واحتلها الأحباش والفرس واليونانيون والرمان لنحو ألفي سنة، وفي هذه الأثناء حيل بين المصريين والجيش، فقد كان كل غازٍ يأتي بجيشه وحاميته العسكرية، ومُنع المصريون من حمل السلاح حتى لا يمثلوا على الغزاة خطرا أو يفكروا في تحرير بلادهم من الدخلاء المعتدين.
الفتح الإسلامي
وعندما جاء الفتح الإسلامي لمصر بقيادة الصحابي عمرو بن العاص، لم يكن لها جيش لأنها كانت ولاية رومانية محتلة، فانتصر المسلمون على الحامية الرومية حتى طردوهم من مصر. وانقسم المصريون إلى ثلاثة أنواع:
- الأول هم المظلومون المضطهدون وكانوا يمثلون الكثرة، وهؤلاء أيدوا الفتح الإسلامي لأنه رفع عنهم الإصر والأغلال والظلم، وأتاح لهم حرية الاعتقاد والعبادة. وكان على رأس هؤلاء قادة الكنيسة القبطية ورعاياها؛ حيث أعاد لهم المسلمون الأنبا بنيامين والذي كان فارا في أحد الأديرة بعيدا عن أعين السلطات الرومانية التي وضعت على رأس الكنيسة بطريركا تابعا لها لاختلاف المذاهب الدينية. وكان ضمن هؤلاء أيضا الآريوسيون (أتباع القديس آريوس الذي عارض ألوهية المسيح وأنه لم يكن أبدا من جوهر الآب؛ لأن المسيح نفسه قال حسب الكتاب المقدس (أبي أعظم مني ـ أبي أعظم من الكل ــ أنت ـ في إشارة إلى الآب ـ الإله الحقيقي وحدك)، وكان يؤمن بأن “بنوة المسيح لله” التي وردت في الكتاب المقدس لم تكن بنوة حقيقية بل كانت بنوة مجازية تطلق على كل إنسان صالح أو نبي من أنبياء الله كما ورد بالكتاب المقدس نفسه (إني لم أصعد بعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم). وجد هؤلاء في الإسلام نفس عقائد آريوس فدخلوا في الإسلام أفواجا وبدأت قطاعات قبطية أخرى من المؤمنين بالثالوث يراجعون أنفسهم وأسلموا طواعية كما يحدث اليوم، فبدأ الإسلام ينتشر طواعية بين المصريين حتى أصبح أكثر من 90% من المصريين اليوم يدينون بالإسلام.
- الفريق الثاني من المصريين وقف يتفرج على الحياد وكأن الأمر لا يعنيه. وهؤلاء هم الطبقات المهمشة المشغولة بأرزاقها اليومية والوثنيون والملاحدة واللا أدرية وغيرهم.
- الفريق الثالث، أيدوا الحكم الروماني لارتباطهم به حيث كان هؤلاء ينتفعون بعلاقتهم مع الرومان وكانوا يخشون تبدل الأوضاع بما يؤثر على أرزاقهم وحياتهم التي اعتادوا عليها، وهم الذين كان يعتمد عليهم الرومان في حكم البلاد والإقطاعيات وبعض التجار والأثرياء.
الغزو الفرنسي
بقيت هذه الأوضاع حتى الغزو الفرنسي لمصر مع الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت (1798 ـ 1801)، حيث ثار المصريون ضد الغزاة وأجبروهم على الرحيل بعد ثلاث سنوات فقط. وكان الطامة الكبرى التي وقعت سنة 1805م حين تولى محمد علي باشا حكم مصر بعد ثورة مصرية عظيمة على الوالي التركي خورشيد باشا، فخلع السلطات العثماني خورشيد لكراهية الناس له، وعين محمد علي واليا على مصر بموافقة شعبية معتبرة لأن محمد علي كان ضابطا ألبانيا في الجيش العثماني تم تكليفه بقيادة فرقة عثمانية لدعم المقاومة الشعبية المصرية ضد الغزو الفرنسي وهو ما أكسب محمد علي محبة من القيادة الشعبية المصرية.
مصر العلمانية
الدولة المصرية الحديثة على النمط الذي أسسه محمد علي باشا في بدايات القرن التاسع عشر (1805 ـ 1848)، لم تكن أبدا على سنة الإسلام وطريقته في الحكم، بل استحوذت على الباشا أطماعه في تكوين إمبراطورية كبرى يكون هو زعيمها وفرعونها، فبدأ بإنشاء جيش نظامي على النمط الأوروبي، واختار قائدا فرنسيا هو «چوزيف انتيلمى سيف Joseph Anthelme Sève» كان ضمن ضباط الغزو الفرنسي في جيش نابليون لتكوين هذا الجيش وتدريبه؛ فأقام الجيش المصري على العلمانية الخالصة التي تعادي الإسلام على طول الخط؛ لأن فرنسا كانت لتوها قد شهدت ثورة علمانية على حكم الكنيسة سنة 1779م. الفلسفة التي أقام عليها محمد عليه جيشه تقوم على العلمانية المحضة والطاعة العمياء والولاء المطلق للحاكم؛ وعبر التجنيد الإجباري كوَّن جيشا نظاميا لا يتمتع بأي مسحة دينية أو أخلاقية أو أي انتماء للوطن بمعناه الحقيقي والشامل، فلم يكن جيش مصر بل كان جيش الباشا. وعاد جيش فرعون من جديد بعد نحو ثلاثة ألاف سنة بنفس الصرامة والقسوة والبطش ليكون أداة الباشا في إخضاع المجتمع. فذبح هذا الجيش من المصريين أضعاف ما قتل من أعداء البلاد، وكان جل من قتلهم من المسلمين المؤمنين الموحدين بالله في مصر و بلاد الحجاز في قمعه للحركة الوهابية و الشام أو حتى في حربه ضد الدولة العثمانية. والمرة الوحيدة التي حارب فيها جيشا أوروبيا تلقى هزيمة مرة في ثورة اليونان أمام الأسطولين الإنجليزي والفرنسي.
عسكرة المجتمع وإضعافه
ورغم أن المصريين تمكنوا كمجتمع من صد حملة فريزر الإنجليزية على مصر سنة 1807م في بدايات حكم محمد على وقبل إنشاء الجيش النظامي، وأجبروا الإنجليز على الانسحاب بعد هزيمتهم في معركة رشيد، إلا أن محمد على قمع المجتمع المصري فنكل بالزعامة الشعبية ممثلة في السيد عمر مكرم، وقتل المماليك في مذبحة مدبرة، وأعطى لنفسه صلاحيات مطلقة منها إقالة شيخ الأزهر وتعيينه ففقد الأزهر استقلاله، ثم فتح البلاد على مصراعيها للجاليات الأوروبية بدعوى بناء مصر على النمط الحضاري الأوروبي، وفي عهد وعهد أحفاده عرفت مصر معنى التنصير والعلمانية، حتى تكونت مئات المدارس التنصيرية والتعليم الأجنبي، وبدأت الأفكار العلمانية تنتشر كفيروس مميت بين هؤلاء ومعظمهم كانوا نصاري وغربيين في بداية الأمر حتى دخل في العلمانية نفر من المسلمين وإن كانوا لا يمثلون نسبة تذكر لكنهم كانوا يتحكمون وحتى اليوم في مفاصل الدولة الثقافية والفكرية في دواوين الحكومة والإعلام والصحافة والمسرح والدراما وغيرها. وحين جاء الإنجليز سنة 1882 لم يجدوا مجتمعا قويا قادرا على صدهم كما حدث من قبل فقد تكفل الباشا بتدمير المجتمع المصري. وعزز الاحتلال مكانة المنصرين والعلمانيين للتلاعب بهوية المجتمع المسلم. وجرى تصميم الحكم على مقاس أهداف الاحتلال السياسية والدينية والفكرية والاقتصادية.
علمانيون في خدمة الجنرالات
على كل حال بقي العلمانيون على الدوام أوفياء للاحتلال من جهة والسلطوية العسكرية التي أنشأها محمد علي وجاءت بهم وفتحت لهم ذراعها ومكنتهم في مصر تمكينا حتى بات لهم تأثير في الرأي العام رغم ضآلة أعدادهم وفساد بضاعتهم من جهة أخرى. وبقي ولاؤهم مطلقا للسلطوية العسكرية في عهد ضباط يوليو 1952م، فأيدوها على طول الخط مع وجود استثناءات قليلة، فصارت المعادلة واضحة (حكم عسكري باطش + نخبة علمانية مرتزقة)، وكلاهما في حالة عداء متجذر مع الإسلام كدين ومرجعية تحكم المجتمع وضد الديمقراطية كوسيلة وآلية من آليات الحكم الرشيد تضمن تنفيذ إرادة الشعب الحرة وحقها في اختيار الحكام والحكومات والأفكار الحاكمة والموجهة للمجتمع. ولهذا كان العسكر والعلمانيون إلى جانب الكنيسة بكل أنواعها(أرثوذكسية ـ كاثوليكية ـ إنجيلية) هم من يقف وراء الانقلاب العسكري في يوليو 2013م وتدمير المسار الديمقراطي الوليد.
لكل ذلك فإن مصر تحتاج إلى تحريرها تحريرا حقيقيا من قبضة العسكر والحكم الاستبدادي من جهة، وتحريرها من فساد الأفكار العلمانية وخيانة نخبتها للأمة والمجتمع، وهي النخبة التي يفرضها العسكر على المجتمع بالقهر والظلم والطغيان. وهذا دور كل مصري مسلم غيور على هذا الوطن وحضارته وهويته الإسلامية.