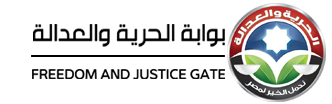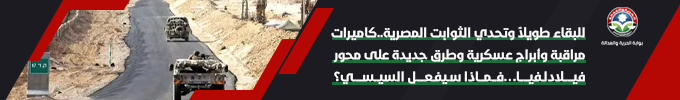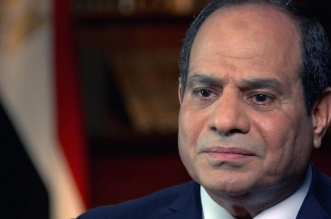بقلم / حسام أبو حامد
لم يقلّ فرح الفلسطينيين السوريين عن فرح أشقائهم السوريين بسقوط نظام بشّار الأسد، إذ يتشاركون معهم حلم عودة إلى سورية حرّة، بعد رحيل ديكتاتورها ونظامه الدموي، وتساؤلاتٍ بشأن ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستحقّق أهداف ثورة السوريين التي انطلقت في العام 2011، تضاف إليها أسئلة فلسطينية مركّبة، وهي أسئلة اللاجئ الفلسطيني الذين تعوّد حمل همومٍ مضاعفةٍ، همّ قضيته وهموم الشعوب المستضيفة.
من تلك الأسئلة ما كان حاضراً، حضور اللجوء الفلسطيني في سورية منذ 1948، ومنها ما استجدّ مع وصول نظام البعث إلى السلطة في سورية، ومنها ما احتدم بعد الثورة السورية، وتعقّد مع انطلاق “طوفان الأقصى”، في 7 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، وتباين مواقف السوريين منه، بين مؤيّد يراه مشروعاً مقاوماً فرضه واقع الفلسطينيين تحت الاحتلال، ومخطّطات تحاك ضدّهم في المنطقة، ومعارض يراه لحظة إيرانيةً في صراعها مع إسرائيل، إذ أصبح كثيرون منهم يرون في إيران (بحكم تجاربهم معها في حماية نظام بشّار الأسد) مشروعاً أشدّ خطراً من المشروع الصهيوني. وبعد سقوط النظام في سورية، تفرض تلك الأسئلة الفلسطينية نفسها بوصفها أيضاً أسئلةً سوريةً، أو لنقل إن الإجابة عنها مرهونةٌ بمستقبل سورية السياسي ما بعد الأسد، وفي ظلّ سعيهم إلى بناء سورية ديمقراطية، دولة مدنية لجميع مواطنيها. وهي لحظة ليس في مصلحة السوريين والفلسطينيين التغافل عنها، حتى إن كان من السابق لأوانه تقديم إجابات واضحة عنها، لكنّ النقاش فيها ضروري من أجل استعادة الثقة بين الشعبين، وتعايش مشترك هو في أقله مفروض على الطرفَين.
عومل الفلسطيني معاملة المواطن السوري، لكن ذلك لم يشمل الحقوق السياسية في الانتخاب والترشّح لمجلس الشعب أو للمناصب السيادية
واجبات كاملة وحقوق منقوصة
بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية في العام 2011، بحسب سجلّات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، 570 ألف لاجئ، سكن 45% منهم في المخيّمات، بينما تشابك النسيجان الاجتماعيان الفلسطيني والسوري خارجها. ومنذ لجوئهم بعد نكبتهم الأولى، عقدت الحكومة السورية اتفاقاً (28 أغسطس/ آب عام 1947) مع المبعوث الأممي الكونت برنادوت يسهّل دخول الفلسطينيين إلى سورية، وتأمين الظروف الملائمة لهم. كما صدر القرار رقم 450 لعام 1949، المتعلّق بإحداث المؤسّسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية، مسؤولة عن تنظيم وإدارة شؤونهم. وتوالت القرارات التي تنظم الوجود الفلسطيني في سورية، منها قرارات بين عامي 1948 و1952، تمنع الفلسطينيين من مزاولة بعض الوظائف، مثل المرسوم التشريعي رقم 33 للعام 1949، الذي منع الفلسطينيين من الحصول على الوظائف في مؤسّسات الدولة وإداراتها، كما منع مرسومٌ تشريعي حمل الرقم 51 للعام 1952 الفلسطينيين من مزاولة مهنة المحاماة. ألغيت هذه القرارات بالقانون رقم 260 الصادر عام 1956، الذي منح الفلسطينيين حقوقاً مدنيِّة في التجارة، والتعلّم، والتوظيف، ومزاولة المهن الخاصة، والانتساب إلى النقابات، كما حصل الفلسطيني في وقت لاحق على حقّ استصدار وثيقة سفر تمكِّنه من التنقّل بحرّية. عومل الفلسطيني معاملة المواطن السوري، لكن ذلك لم يشمل الحقوق السياسية، في الانتخاب والترشّح لمجلس الشعب، أو للمناصب السيادية، كما قُيّدت ملكيته (استقر الأمر عند أن يتملّك الفلسطيني منزلاً واحداً فقط، بعد موافقات إدارية وأمنية). وفي مقابل حقوق منقوصة، ترتّبت على الفلسطينيين واجبات كاملة، بما فيها خدمة العلم (في جيش التحرير الفلسطيني الذي أصبح خاضعاً لقيادة الأركان السورية)، كما اقتُطع من راتب الموظّف الفلسطيني 5% لصالح منظمة التحرير الفلسطينية، ذهبت خلال سنوات طويلة إلى جيوب نظام الأسد (الابن والأب) حتى سقوطه.
واجه ديكتاتور دمشق السابق حافظ الأسد، بالحديد والنار، معارضةً إخوانيةً مسلّحةً ضدّ نظامه في السبعينيّات والثمانينيّات، فوسّع السجون ومراكز الاعتقال، تحوّلت معه البلاد مسلخاً بشرياً كبيراً، كانت مدينة حماة أبرز ضحاياه. تراجعت المعارضة السورية الشعبية إلى داخل البيوت وبين جدرانها، وتلاعب حافظ الأسد بالقضية الفلسطينية شعاراً في حروبه مع إسرائيل في أراضي الآخرين (لبنان تحديداً)، وورقةً لتثبيت حكمه، فخاض مغامراته السياسية والعسكرية لاحتكار القرار الفلسطيني وإخضاع منظّمة التحرير الفلسطينية، وانحصرت المعارضة السياسية السورية في يسار سوري، في معظمه مثقّفون من أبناء الأرياف السورية و”الأقلّيات”، ومعهم شريحة واسعة من المعارضين الفلسطينيين، شكّلوا معظم نزلاء سجون ومعتقلات الأسد المُحدّثة اعتباراً من الثمانينيّات. أخضع الأسد (الأب) السوريين، وسادت الشارعَ رغبةٌ في النجاة عبّرت عن نفسها صمتاً عاماً تجاه تصفية الأسد حساباته مع “أعداء الداخل”، في مقابل فروسيته المتوهمّة تجاه “أعداء الخارج”. وكثيراً ما قوبل الفلسطيني الناقد النظامَ بالمثل الشعبي: “قاعد بحضنا وعم تنتف بدقنا”. وكان فرع فلسطين (الفرع 235) التابع للمخابرات العسكرية السورية، في دمشق، الذي أُسّس في عام 1969، همزة وصل بين الحكومة السورية ومختلف الجهات الفلسطينية المسموح لها العمل في سورية، وكان على أيّ فلسطيني يريد السفر أن يحصل على إذن من هذا الفرع سيئ السمعة (ألغي إذن السفر في عهد بشّار الأسد، واستبدل به إذن سفر في حالات معينة عبر إدارات الهجرة والجوازات)، ويعتقد أن الفرع المذكور كان أحد مراكز الاعتقال التي استعانت بها الولايات المتحدة للمشتبه في انتمائهم إلى منظّمات إرهابية، في واحدةٍ من صفحات مناورات نظام بشّار الأسد لتوطيد حكمه للسوريين. بقي بطش فرع فلسطين مسلّطاً على رقاب العباد، فلسطينيين وسوريين.
اعتقل النظام السوري السابق أكثر من 3085 فلسطينياً، من بينهم 127 امرأة و45 طفلاً، ما بين عامي 2011 و2014 فقط
اللاجئون الفلسطينيون والثورة
انخرط اللاجئون الفلسطينيون في سوق العمل، ولم يكونوا عالةً على مضيفيهم، بل شاركوا في العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاصّ. وشهدت مخيّماتهم نشاطاً سياسياً وثقافياً عُدَّ متقدّماً بالنسبة إلى الحالة السورية، وإضافة إلى سوريين انضمّوا إلى صفوف الثورة الفلسطينية مقاتلين، انضمّ إلى الحراك المذكور في المخيّمات مثقّفون سوريون، وجدوا فيه متنفّساً بعد احتكار النظام مجالهم العام. مع ذلك، بقيت المخيّمات الفلسطينية تحت المراقبة الأمنية المشدّدة، سادت معها النظرة الأمنية في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين، وكان الجميع، فلسطينيين وسوريين، متّهمين حتى يثبتوا الولاء للنظام بطرائق شتّى.
تشابك النسيجان الاجتماعيان الفلسطيني والسوري مجدّداً، وهذه المرة داخل المخيمات، فبعد انتعاش مخيم اليرموك (أكبر تجمعات الفلسطينيين في سورية) اقتصادياً مطلع التسعينيّات، أصبح بيئة جاذبةً للسكن والاستثمارات الاقتصادية، وربّما تجاوز عدد السكّان السوريين في أحياء المخيّم المستحدثة (وتوسّعه) عدد لاجئيه من الفلسطينيين.
مع انطلاق الثورة السورية في العام 2011، خشي الفلسطينيون السوريون من أن يشهدوا مصيراً مشابهاً لمصير فلسطينيي الأردن (أيلول الأسود 1970-1971)، أو مصيرهم في أتون الحرب الأهلية اللبنانية (1976-1990)، التي تخلّلتها اجتياحات إسرائيلية وسورية، ثمّ مصيراً مشابهاً لبني جلدتهم في الكويت بعد الغزو العراقي (1990)، ثمّ العراق إبان الاحتلال الأميركي (2003). لكن تجمّعاتهم وقعت في براثن استقطاب حادّ بين المعارضة والنظام، كان معه الحياد مستحيلاً، وتورطوا في الثورة السورية، إنسانياً أولاً، بدءاً بإيوائهم سوريين نازحين هاربين من بطش النظام من بلدات ريف دمشق الملاصقة لمخيّم اليرموك، وبدأت التظاهرات المناهضة للنظام تمتدّ في داخل المخيّم، بينما شكّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ما سمّتها “لجاناً شعبية” مسلّحة لمنع دخول هؤلاء النازحين، والحيلولة دون مزيد من التظاهرات. المجزرة التي نفّذتها طائرات النظام السوري (ديسمبر/ كانون الأول 2012) بحقّ المصلّين والنازحين في جامع عبد القادر الحسيني كانت نقطة تحول دراماتيكية في مصير المخيّم. غادره كثيرون، قبل أن يُطبِق النظام ومليشيات فلسطينية حصارها عليه. حصار طاول 18 ألفاً، قُتِل خلاله مئتان من سكّانه جوعاً ومرضاً، وهو ما اعتبرته منظّمة العفو الدولية جريمة ضدّ الإنسانية، ناهيك بعشرات المعتقلين.
تفتيت المجال السوسيولوجي الفلسطيني
بسيطرة النظام وعملائه على مخيّم اليرموك، خلا من سكّانه، وأعلن النظام مخطّطات “إعادة إعمار” تُبقي 40% من أحياء المخيّم القديم، وتحوّله حيّاً دمشقياً، مع تعويضات هزيلة لسكّان المناطق الخاضعة للتنظيم الجديد. شهدت المخيمات لاحقاً عودةً محدودةً لبعض السكّان عبر بوابات أمنية. بكل حال، فُتّت مجال الفلسطينيين السوسويولوجي في عموم سورية، وغادرها معظم الفلسطينيين الذين شاركوا سوريين قوارب موت أبحرت بهم نحو أوروبا، أو عبروا معهم المنافذ البرّية الرسمية وغير الرسمية تحت زخّات رصاص حرس حدود دول الجوار. وبقي منهم في العام 2022، بحسب تقديرات، 40 ألفاً عاش 3% منهم في ما تبقى من مساحات في مخيّماتهم المدمّرة، وتقاسم الباقون عموم الجغرافيا السورية. توزّع سكّان مخيّم اليرموك (وفق موافقات أمنية مدروسة) بين مناطقَ في أرياف دمشق وضواحيها. وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قُتِل 3207 لاجئين فلسطينيين بيد قوات النظام ما بين مارس/آذار 2011 وأكتوبر/ تشرين الأول 2022، ووثّقت مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سورية اعتقال النظام السوري السابق أكثر من 3085 فلسطينياً، من بينهم 127 امرأة و45 طفلاً، ما بين عامي 2011 و2014 فقط. وقد يكون العدد أكبر من ذلك إذا ما أخذنا بالاعتبار من أعتقل بعد تلك المدّة. وكشفت السجون المحرّرة بعد سقوط النظام، بحسب “المجموعة”، مصير 42 منهم فقط، منهم من لا يزالون يبحثون عن ذويهم من دون أن يجدوا لهم سبيلاً، أو يعلموا في أيّ أرض يقيمون.
في السنوات اللاحقة للثورة السورية، شعر اللاجئون الفلسطينيون بتوجّهات تنتقص من وضعيتهم القانونية
الفلسطينيون في حُكم الأجنبي
في السنوات اللاحقة للثورة السورية، وإضافة لتشديد المراقبة الأمنية، شعر الفلسطينيون بتوجّهات تنتقص من وضعيتهم القانونية، فأزيلت عبارة “من في حكمهم” التي كانت تأتي معطوفة في القرارات السورية على كلمة “السوريين”، واستثنوا من حقّ التقدّم لأيّ وظائف حكومية، وحرمهم القرار رقم 1011 الصادر عن مجلس الوزراء السوري عام 2021 من حق المليكة، حين نصّ على تعديل الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون تملّك الأجانب العقارات، لتصبح “يقصد في عبارة غير السوري أيّ شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل الجنسية العربية السورية”، من دون استثناء اللاجئين الفلسطينيين من نصّ القرار الذي كشفه ناشطون حقوقيون من دون إعلان رسمي من حكومة النظام البائد. وأيضاً، لم يعد بإمكان من هم في خارج البلاد منهم توكيل ذويهم في الداخل السوري لتسيير أمورهم، كتلك المتعلّقة ببيع ممتلكاتهم أو تقديم استقالاتهم، ونحوها.
قبل سقوط النظام، خشي الفلسطينيون من أن تسوية سياسية هشّة، تفرضها القوى الدولية في سورية تنهي الصراع، قد تدفع باتجاه استقرار ظاهري مؤقت يبقيهم تحت رحمة مناورات سياسية داخلية وخارجية، خصوصاً بعد رسائل إيجابية وجهتها شخصيات سورية معارضة إلى الاحتلال الإسرائيلي، تقابلها أخرى من رموز النظام السوري، تمثّلت في مقولة رامي مخلوف الشهيرة “أمن سورية من أمن إسرائيل”. كما خشي اللاجئون الفلسطينيون من أن ينتهي الصراع بتفكّك الدولة السورية، فيصبحوا ضحيّة إعادة تعريفهم وتموضعهم طائفياً وديمغرافياً، ليبقى مصيرهم معلّقاً بهوية النظام السياسي المقبل في سورية.
سقط النظام، وتحتاج مؤسّسات الدولة السورية إلى إصلاح. لكنّ الفلسطينيين لمسوا خطوات مبشّرة تشي بانتباه السلطات القائمة حالياً إلى وجودهم، فأزيلت حواجز النظام البائد الأمنية من مخيّم اليرموك، وأصبحت حركتهم منه وإليه حرّةً، كما سُمح للفلسطينيين السوريين، بحسب ما توارد من أخبار، بالعبور من لبنان إلى سورية من دون جوازات سفر اكتفاء بهويتهم الشخصية السورية (تذكرة الإقامة المؤقتة للاجئين الفلسطينيين التي منحتها لهم السلطات السابقة). وهناك تقارير (لم تتأكد صحتها) عن اجتماع أمني عقدته الإدارة العسكرية السورية الحاكمة سوريةَ حالياً مع فصائل فلسطينية، بهدف نقاش تسوية وضع معسكرات الفصائل الفلسطينية وأسلحتها الموجودة في الأراضي السورية.
طبعاً، لا يحتاج الفلسطينيون في سورية إلى أسلحة، ولا يريدونها، بل يطالبون بمحاسبة من نكلّ بهم بسلاحه، سواء حمل هذا السلاح فلسطينيون أو سوريون، فهم يتوقون كما يتوق السوريون إلى عدالة انتقالية يستحقّونها، تشمل تقصّي وكشف الحقائق والملاحقات القضائية والتعويضات (مادّياً ومعنوياً)، وتدابير منع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فيها الإصلاح الدستوري والقانوني والمؤسّسي، وتقوية المجتمع المدني… إلخ.
خاتمة
إذاً، في ظلّ وحدة المصير، ستجيب المرحلة السورية المقبلة عن تساؤلات فلسطينية، تتعلّق بوضعيّتهم الاجتماعية القانونية، هل سيعودون إلى وضعية واجبات كاملة في مقابل حقوق منقوصة؟ أم سيعاملون باعتبارهم أجانب؟ أم لاجئين؟ ما يعني أن تطبّق عليهم القرارات الدولية بخصوص اللاجئين التي تلزم سورية بوصفها عضواً في الأمم المتحدة، وهل ستمنح أجيال اللاجئين الفلسطينيين بعد 76 عاماً من الإقامة والعمل الجنسيةَ السورية (ولا يتعارض هذا مع حقّ العودة)، كما منح اللاجئون السوريون الجنسية في دول أوروبية بعد إقامتهم فيها مُدداً تتراوح بين خمس وعشر سنوات؟… تمكُّن السوريين (ومعهم الفلسطينيين) من تحقيق أهداف الثورة السورية بدولة المواطنة يعني إجابات مقنعة عن الأسئلة الفلسطينية، أمّا خلاف ذلك (وهو ما لا يتمنّاه كلُّ مُحبٍّ لسورية)، فيعني تفكيك المجال السوسيولوجي الفلسطيني في سورية من غير رجعة.
تمكُّن السوريين من تحقيق أهداف الثورة السورية بدولة المواطنة يعني إجابات مقنعة عن الأسئلة الفلسطينية
صحيح أن الفلسطينيين انقسموا بين موالاة ومعارضة، فإلى جانب فصائل وقفت مع النظام (وهي تاريخياً لم تتردّد في حمل السلاح في وجه أشقائهم الفلسطينيين الذين لم يرضَ عنهم نظام الأسد أباً وابناً، وزجّت في سجونه آخرين)، هناك فلسطينيون أفراد شاركوا في الثورة المسلّحة ضد النظام، حتى حركة حماس، قاتل 300 من عناصرها النظامَ في مخيّم اليرموك، واتهمها نظام الأسد بمساعدة الثوار في غوطة دمشق في حفر الانفاق وصناعة العبوات المتفجّرة… نقول، صحيح أن الفلسطينيين انقسموا بين موالاة ومعارضة، لكن حالهم في ذلك حال السوريين، فالفلسطينيون في نهاية المطاف جزء من نسيج المجتمع السوري.
كما آن أوان حسم الجدل بشأن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يثبت باحتلاله مزيداً من أراضٍ سورية أنه عدوٌ ليس للفلسطينيين فقط، بل لأيّ شعب يريد التحرّر من الاستبداد، الاستبداد الذي يحميه الاحتلال ويحتمي به. والدرس السوري يقول إن طريق القدس لا يمرّ عبر تثبيت قوى القهر والاستبداد، فما من معنى للتحرير من دون حرّية، بل هل هو ممكن؟… في الأحوال كلّها، وبعد أكثر من عام على “طوفان الأقصى”، ندرك أن إيران كانت عائقاً أمام حلم السوريين بالحرّية، حين حمت النظام سنوات، لكنّها لم تحمِ الفلسطينيين في غزّة، ولا حليفها حزب الله في لبنان. ولم تقاتل إسرائيل كما استشرست في القتال إلى جانب الأسد، وتبدو الطريق ممهّدة اليوم لضرب المشروع النووي الإيراني أميركياً وإسرائيلياً، وربّما إسقاط النظام في إيران (مع أن من يناط به ذلك هو الشعب الإيراني). صحيح أن إسرائيل استفادت من سقوط النظام في سورية، وتصفية الوجود الإيراني فيها، وقطع الذراع الإيرانية الممتدّة إلى حزب الله، لكن ذلك لا ينبغي أن يعكّر فرحة السوريين، وفرحتنا، بسورية حرّة من دون استبداد. دعم القضية الفلسطينية لا ينبغي (ولم يكن ينبغي) له أن يكون على حساب الشعوب الأخرى، تنعدم قيمة هذا الدعم أخلاقياً، وحتى براغماتياً. الحرّية والتحرّر من الاستبداد والاحتلال والتبعية مسؤولية شعوب المنطقة متمتّعةً بالحرّية، تحكم نفسها بنفسها، مواطنين لا رعايا، وستبقى إسرائيل العدو الأول للسوريين والفلسطينيين واللبنانيين وللإنسانية جمعاء، ومشروعاً عنصرياً إحلالياً، ينبغي توفير الأدوات والإمكانات الذاتية لمواجهته.