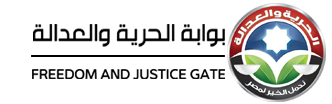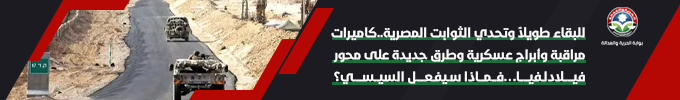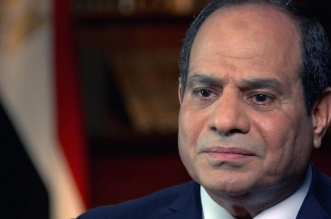نعيش في تلك الأيام الكاحلة ذكرى انتصار أبناء مصر الذين ضحوا بدمائهم من أجل وطنهم ، ففي 6 من شهر أكتوبر 1973 عاش العرب والمصريون يوما للكرامة والبطولة التي سطرها آباؤنا بأحرف من نور ودماء ذكية؛ دفاعًا عن الأرض والعِرض والدين، واسترداد سيناء من الصهاينة وتحرير التراب العربي.
وما أشبه اليوم الذي نحتفل به بالذكرى الـ 51 لكن مع اختلاف الغايات والعقائد فقبل 6 أكتوبر 1973، كانت القاهرة وقتها لا تزال تحت أثر صدمة نكسة يونيو 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل شبه جزيرة سيناء والجولان السوري وقبلهما طبعا ما تبقى من أراضي فلسطين التاريخية أي الضفة الغربية وقطاع غزة.
ليتشابه اليوم بالوهن الذي كان يسيطر على العرب قبل الانتصار، فالقاهرة الآن محتلة من مجرم انقلابي صهيوني قدم لإسرائيل ما لم يقدمه أعز فلذاتها ، ومازلت الجولان محتلة وإسرائيل الآن تعثوا تدميرا في لبنان وفلسطين، وتنفذ حرب إبادة ضد الجميع.
احتفالات على دماء الشهداء
وحول آباؤنا حرب الغفران كما يحلو للدولة العبرية أن تسميها لحدوثها في عيد الغفران اليهودي لتجعل أكتوبر نكسة على اليهود، بعدما تم تدمير خط بارليف والعبور إلى الضفة الأخرى من قناة السويس، وقد تم الهجوم المفاجئ بالتنسيق مع الجيش السوري الذي شن عملية عسكرية ضد جيش الدولة العبرية على هضبة الجولان المحتل.
وقد حظيت مصر وسوريا بدعم عربي سياسي وعسكري واقتصادي كبير، إذ شهد العالم صدمته البترولية الأولى حسب التسمية الغربية، حيث قررت الدول العربية المصدرة للنفط في 15 أكتوبر 1973 حظر تدفق الذهب الأسود على الأسواق الغربية ممثلة في الولايات المتحدة وأوروبا، وقد استمر هذا الحظر حتى مارس من عام 1974.
لكن اليوم اجتمع كل رؤساء الدول العربية على عكس أسلافهم الذين ضحوا بالغالي والنفيس ضد الصهيونية، لنشهد هذا العام ذكرى جميلة نرقص بها على دماء إخواننا في لبنان وفلسطين، اللذان تحت مرمى القصف الصهيوني تحت غطاء ودعم العديد من رؤساء وملوك العرب .
ماذا تبقى من حرب أكتوبر 1973؟
تختلف النظرة الآن لهذه الحرب الباسلة باختلاف الأطراف المعنية، فإذا كانت القاهرة تعتبرها نصرا كبيرا فإن إسرائيل أيضا تعتبرها انتصارا، لأنها وبواسطة الهجوم المضاد الذي شنته، استطاعت الوصول إلى مسافة تبعد عن القاهرة بأقل من 100 كلم قبل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، ومن ثم استطاعت أن تحول الساسة المصريين إلى عملاء خانعنين لها.
ومع أن هذه الحرب مقد كسرت أسطورة الجيش الذي لا يُقهر الذي استطاع في ستة أيام احتلال الضفة والقطاع وسيناء وهضبة الجولان، كما أنها غسلت نوعا ما عار نكسة يونيو وعكست تضامنا عربيا ندر وجوده في السنوات التي تلت حرب أكتوبر وكرّست أيضا ريادة القاهرة كزعيمة للأمة العربية.
في ذات الوقت عزز الجيش المصري أكثر فأكثر من قبضته على مفاصل الدولة في البلاد، ومن ثم توغل الصهاينة داخل هؤلاء العسكر ليصبحوا عملاء أصحاب ولاء أكثر من اليهود أنفسهم.
معاهدة سلام واتفاقيات وتطبيعات
يبدو جليا أنه لم يتبق من نصر أكتوبر 1973 سوى الأطلال، فالخنوع والذل هو ما يتميز به قادة العرب الآن بعدما عقدوا اتفقيات ومعاهدات وتطبيعات أضرت بمكتسبات حرب 73، فمعاهدة كامب ديفيد والتي من خلالها باع نظام الرئيس محمد أنور السادات حقوق مصر والعرب باتفاقية سلام مع إسرائيل ليعترف العسكري خليفة عبد الناصر بالدولة العبرية وقبلت الأخيرة باعادة شبه جزيرة سيناء إلى حضن القاهرة كشرطين أساسيين لاتفاقية كامب ديفيد التي تم التوقيع عليها عام 1978 والتي كانت سببا في مقتل السادات على يد الضابط المصري خالد الإسلامبولي خلال عرض عسكري في السادس من أكتوبر عام 1981.
لكن رغم السلام بين الدولتين وتوقيع كامب ديفيد ورغم مرور كل هذه السنوات، فإن الشعب المصري مازال يبغض الصهاينة رغم حكامه العملاء الذي صرفوا المليارات لطمس هويتهم بداية من السادات ومرورا بمبارك وانتهاء بكلب الصهاينة عبدالفتاح السيسي.
فسوريا تحولت إلى ركام تحت يد الدكتاتور بشار الأسد، الأردن بدوره دخل في مسار سلام وتطبيع مع إسرائيل بتوقيعه على اتفاقية وادي عربة عام 1994، لتقتفي أثره كل من الإمارات والبحرين المغرب من خلال اتفاقية أبراهام التي رأت النور عام 2020 تحت رعاية أمريكية أثناء ولاية الرئيس دونالك ترامب.
أما الفلسطينيون فرغم توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، لا يزال السلام أمرا بعيد المنال، خصوصا مع وجود حكومة يمينية يقودها زعيم الليكود بنيامين نتنياهو وتضم غلاة المتطرفين، إذ لا تزال الضفة الغربية محتلة ومقطعة الأوصال بسبب المستوطنات والطرق الالتفافية، أما قطاع غزة فهو يدق بالصاوريخ والقنابل منذ أكثر من عل ما جعله أكبر مقبرة وسجن في العالم.